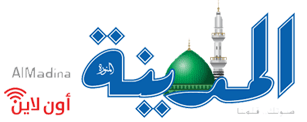من شرفة بيتي الجديد، بعيد انتصاف الليل، وقفتُ أطل على بيتنا القديم! كان الحنين الذي لم يجف في صدري، يجعلني أستنشق رائحته كل حين.
هرعت إليه.. فكل غرفة هنا لها عبقها الخاص.. هذه رائحة الطيبة تنبعث من غرفة أمي، وهذه رائحة الفِكر تنساب من غرفة أبي، وهذه رائحة الألفة تخرج من غرفة البنات، وهنا تنبعث رائحة الكرامة من غرفة الأولاد.
دخلتُ غرفة أمي التي خلتها تشتاق إلى «اللمة»، حيث جلسات الفول السوداني والبرتقال واليوسف أفندي.. حول الوجه الحبيب.. وحين هممتُ بالخروج خلتها تناجيني بانفعالٍ شديد: لا تتركوني حزينة أو وحيدة عند كل مغيب.. كان مطبخها العامر يسألني التمسك بأيام وطقوس الزبدة والجبنة والعسل والحليب، وحين كان أخي الأكبر يجهز لنا ذبائح العيد، كانت سيارة أخي الأوسط تلوح من بعيد.
خرجتُ إلى الفراندة البحرية.. صوت أم كلثوم هنا عند الخامسة مختلف، وصوت الشيخ عبدالباسط الذي تتركه مرضية طوال الليل يملأ المكان نوراً.. ويأتلف.
ها قد حانت ساعة المواجهة! يسألني بيتنا القديم: ترى ما الذي أبقيتم مني؟!.
يسألني عن سر دمعي المخزون منذ بكيت أمامه على اقتلاع شجرة الزيتون.. يسألني بوضوح: ما الذي تنوون؟ وهل صحيح أنكم ستبنون؟!.
يُوصيني بيتنا القديم: إذا هدمتوني وأعدتم بنائي، فاملأوا جنباتي بما ترك لكم الراحلون! بالحب والتسامح.. بالألفة وبالحنين حتى لا يفتتن الآتون!.
في تلك الليلة، ظل بيتنا القديم يُعاتبني أو يُراوغني أو يُكاشفني في حديقة التناسي! يصرخ تارة ثم يناديني كطفل.. كان يُضاحكني.. وكنتُ أظنه صار كهلاً وصار وجهه منطفئاً، قبل أن أكتشف أنه جهز لي في تلك الليلة «كمين اشتياق»، جعلني أفر إليه صبيحة اليوم التالي وأنا تنتابني حمى عناق!.
في المساء قال تعال! عندنا وقت فلا تتعجَّل! بُح لي بما يحزنك ويضنيك ويدمعك.. لا تخجل!.
ألم نكن نتلاقى فتخفف من ملابسك بلا وجل كأوراق الشجر؟، هل نسيت ذكرياتنا وصوت المطر؟، دع عنك هذا اليأس بل هذا الذبول.. كنتُ ومازلت مرآتك، وأدرك ما يخاف قلبك أن يقول!.
لا تترك صورة أمك وقد صارت ملامحها دموعاً! لا تترك قطة في بيتها أو حمامة تظمأ أو تجوع.. سيعود البعيد من جديد، وستحتفون بوليدٍ يتبعه وليد.. فلا تتركوني أسيراً للشقوق أو التجاعيد!.
هالني حين وقعت عيني في بقايا مكتبة بيتنا القديم على سطور من رسائل الجاحظ في الحنين إلى الأوطان والبلدان، ما ذكره أعرابي عن بلده قائلاً:
«رملة» كنت جنين ركامها ورضيع غمامها، فحضنتني أحشاؤها، وأرضعتني أحساؤها.
وكانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفراً تستنشقه عند نزلة برد أو زكام أو صداع!.
قالوا: ولم نجهل ولم ننكر أن نفس الإلف يكون من صلاح الطبيعة، حتى أن أصحاب الكلاب ليجعلون هذا من مفاخرها على جميع ما يُعاشر الناس في دورهم، من أصناف الطير وذوات الأربع، وذلك أن صاحب المنزل إذا هجم «هدم» منزله، واختار غيره، لم يتبعه فرس ولا بغل ولا ديك ولا دجاجة، ولا حمام، ولا حمامة، ولا هر ولا هرة، ولا شاة ولا عصفور، فإن العصافير تألف دور الناس، ولا تكاد تقيم فيها إذا خرجوا منها، والخطاطيف تقطع إليهم فيها إلى أوان حاجتها إلى الرجوع لأوطانها.
هل كانت مصادفة أن أقرأ هذه السطور، وأن أكتب عن بيتنا القديم؟، وهل كان الحوار معه بالفعل، وهل كنت أُحملق في وجهه هو أم في وجه أبي؟!.
هل كان صوته؟ أم صوت أبي؟!.