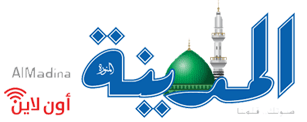لم تكن محطة القطارات في قريتي مجرد رصيف أو قطار يمضي وآخر يعود!، لم تكن مجرد قطارات ومواعيد، وصخب وضجيج، بل كانت ساحة للجمال والإبداع والخيال. يسطع وجهها مع كل قطار، وكأنها تستعد لاستقباله، فإذا ما مضى، مخلفاً الغبار، راحت تبدده من حولها، وتردد بينها وبين نفسها: «يجي عالمحطة يجي.. بس الوله يجي»!
وكان لمحطتنا ناظر مهذب اسمه «أحمد سالم» جاء من بلد بعيد، وحصل على «سكن» تابع لهيئة السكة الحديد، قبل أن يحصل على سكن آخر في قلب «الرملة» التي أحبها وأحبته، وشاركت معه في تربية وتنشئة أولاده وبناته، فصاروا مهندسين وأطباء ومعلمين.
لقد حرص ناظر محطتنا فور تسلمه «السكن» على أن يزرع أشجاراً ووروداً وريحاناً، ويزرع في نفوس الأبناء والبنات «فوزي وعادل وفائزة» رضا وتسامحاً وصبراً جميلاً.. كانت فائزة في معظم الوقت تلوذ بالصمت، وترفض الثرثرة.. لمحتها ذات مرة، تلهو مع أطفال القرية، قبل أن تعود نافرة.. كانت لا تجيد اللعب بالتراب، والصياح والمهاترة!.
وعلى الطرف الآخر من محطة الرملة، من جهة «سمادون» سكن آخر لموظف الدريسة العم «عليوة» الذي جاء من بلد آخر، وتعايش هو وأولاده، وبناته، حتى أننا كنا نحار.. لأي العائلات ينتسب هذا الرجل؟!لقد كان من عبقرية الرملة أن من يدخلها موظفاً أو طبيباً أو مزارعاً أو حداداً أو نجاراً صار منها.. يسكن في قلبها قبل أن تسكن هي في قلبه! حدث ذلك مع الدكتور «حسين» ومع مهندس الإصلاح «حمدي المعداوي» الذي أطلق المزارعون أسمه على مواليدهم.. وحدث مع مزارعنا «رمضان عزب» ومع مزارع عمي «محمود رسلان» ومزارع عمي الآخر «محمود حشاد».. بل إنه حدث مع نجارين أقباط مثل العم فهمي، وأولاده: فوزي وصبحي وسليمان وفايقة.. وحين مات صبحي خرجت الرملة عن بكرة أبيها تشيعه الى قرية مجاورة تضم مدافن للمسيحيين!.
قبل شهور قليلة، وفيما كنت أمر بسيارتي عبر مزلقان المحطة، آثرت النزول، وكما لو كنت أسمع صوتها.. تعاتبني وهي تدندن: أنا التي أرسلتك للقاهرة، تدرس الفلسفة وتعمل بالصحافة، وأنا التي ملأتك بالجمال وبالتأمل قبل أن تغادر مصر الى لندن!
كنت أدرك أنها تقاوم الزمن وتخاف أن تشيخ! الشعراء الذين وقفوا عليها وأحبوها، رحل بعضهم وهاجر الآخر، والأطباء والمهندسون والمحامون بل والمعلمون باتوا يستسهلون ركوب السيارات بدعوى توفير الوقت، والطريق الإقليمي الجديد، فعل فعلته، وتركها تعاني بعض الهجر!.
لقد كانت المحطة بالنسبة لنا، غبشة الفجر الجميل، وبداية السعي والكدح النبيل، فإذا سافرنا أو عدنا ليلاً استلمنا صديقها القمر، يتابع خطونا فنغني له ولها أينما نسير! نتزود منه ومنها بالحنين، ونزداد تمسكاً به وبها، لأنهما يضيئان طريقنا ويملآن نفوسنا بالإصرار وباليقين!
كنت أعرف أن القادمين اليها، خاصة من القاهرة والجيزة وحلوان هم نورها وبهاؤها، وأن المغادرين لها هم مستقبلها وأملها.. لقد اكتشفت أن «المحطة» هي «الرملة» شكلاً ومعنى وقيمة! ولأن ذلك كذلك، لم أنبهر كثيراً بمعظم الأفلام والمسرحيات التي تحكي عن محطات القطارات.
شاهدت مسرحية «المحطّة» (1973) لفيروز والأخوين رحباني، والحق أنني وجدت نفسي فيها! لقد كان الإصرار على انتظار الأمل عند «وردة» طبيعياً وجميلاً، حتى وإن جاء على هيئة قطار تلوح أدخنته من بعيد! فكلّ قطار لا بدّ له من محطّة يتوقّف بها، لنقل المسافرين إلى زمان مختلف تتجدد فيه الحياة!.تنطلق أحداث المسرحية من حقل البطاطس الذي يعمل فيه مالكه «سعدو»، وزوجته هدى حداد، فيغنيان معاً أغنية «خلص الصيف، الشتي جايي، ولفح الدني تشرين.. نده الغيم الشتي جايي على ريش الحساسين»! ينشرح الصدر مع رسم هذه الصورة القروية المعبرة والزاخرة بالجمال، حيث تشرق الشموس وتزدهر الطبيعة، قبل أن تأتي فتاة من المجهول تغني «ليالي الشمال الحزينة».. تتوقّف قربهما وتسألهما: «وصل الترين.. القطار»؟ يمتد الحوار اللطيف، وأنا أصرخ:
أواه يا محطتي الواقفة الصامدة الصابرة المنتظرة «بس الوله يجي»! قطعت من خلالك ألف رحلة ورحلة، وحين عدت، اكتشفت أن حنيني إليك، ولهفتي عليك، سطعت أكثر وأكثر في الغربة!.