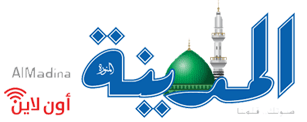لا أظن أن أحدًا في قريتي شعر بنقص تجاه أبناء المدينة، خاصة فيما يتعلق بالطعمية السخنة والعيش الطابونة، على النحو الذي ظهر فيه الممثل المثقف العبقري علي الشريف في فيلم «الأرض».. وكنت كلما شاهدت الفيلم، أتوقف بدهشة أمام «دياب» وهو يجري حافي القدمين تحت الشمس الحارقة، خلف أخيه، وفور أن يصل إلى محطة السكة الحديد في المركز، يلمع في عينيه الهيام والغرام والعشق المكتوم لأقراص الطعمية! لكننا في الحقيقة، لم نكن محرومين لا من الطعمية، ولا من ركوب القطار! ومع وصولنا للمرحلة الإعدادية في السبعينات، جاء الانفتاح الاقتصادي بالشاورما والبولبيف، واللانشون، وبالفراخ المستوردة المشوية! قبل تلك الفترة، لا أدري على وجه الدقة، وعلى مستوى القرية والقرى المحيطة، هل كان الاحساس بقيمة «الطعمية» جارفًا الي هذا الحد؟!
وهل كان الحصول عليها صعبًا لهذه الدرجة، أما لا!
وكنا مع نسمات الديمقراطية التي هبت على فترات متقطعة في عهد الرئيس السادات، نستمع للشيخ إمام وهو يردد مع الشاعر فؤاد نجم، ما قالاه في السجن بعد نكسة 1967 على سبيل الطمأنة والسخرية في آن واحد: «يا أهل مصر المحمية بالحرامية.. الفول كتير والطعمية والبر عمار.. والعيشة معدن وأهي ماشية وآخر أشيا.. مدام جنابو والحاشية بكروش وكتار» كما استوقفتنا كثيرًا تلك المداخلة أو المساجلة بين الشارع الذي يعاير الحارة، في قصيدة صلاح جاهين، قائلا: «إخييه! ريحتك طعمية، وفول وبصارة.. آييياه! كل بيوتك بغدادلى، مافيهاش تكييف.. وبيبانك نازلة لتحت، بدل ماهى طالعة لفوق، ولا حتى ليكى رصيف!
وستاتك بلدي، وليل ونهار ع العتبة، قاعدين كده جوق.. رجالتك نكتة وعجبة، ولا يعرفوا ذوق، وعيالك دول، نسانيس مقاصيف الرقبة! الحارة ردت رد... خلى الشارع ينسد»!!.
والحق أن شارع الطعمية الرئيسي في قريتي لم يعاير أي حارة، ولم يكن البيع والشراء فيه خاضعًا لحسابات الربح والخسارة! يطلع النهار، وقبل أن نتوجه لمدرسة علي الشيخ، وقبل موعد الطابور، ينطلق صوت «البابور»، ويصبح الشارع مضمخًا برائحة الطعمية والفول، والبهار.. نتقاطر على الشارع كالعصافير! تختلط رائحة الزيت، برائحة الكتب والكراسات! فاذا ما حال الزحام دون الحصول على «شقة وطعمية» انتظرنا لجرس الفسحة، فعدنا من جديد للشارع الجميل! في المحل الأول، يقف العم سعد، وبجواره زوجته الطيبة، يهشان في وجوه الزهور.. يدق قلبهما مع قطار الخامسة، فقد حان موعد القيام، للاتيان بكافة المكونات، من بقدونس ومن بصل ومن كرات.. تقف الزوجة شامخة وشاهقة، تنصح الكبار، وتضحك في وجوه الصغار، كأنهم عصافير، تود لو أطعمتهم كلهم، قبل انغلاق باب المدرسة، ويصبجون خلف السور! وفي المحل الثاني، يقف الوديع عبدالله، الذي لم ينهر يومًا فتى أو فتاة.. حيث الرضا أول ما يرى فوق الجباه، وحيث الدعاء بالنجاح أول ما يخرج من الشفاه! وفي المحل الثالث، يضبط العم زيدان ايقاع يومه على أصوات البوابير، فان تعطل أحدها في ثانية، بادر بتغيير «الطربوش» أو «الفونية»! وفي الجهة الثانية من القرية «الناحية دكهه» يقف الخال السيد عمر صانع البهجة، مزهوًا بما يخرج من الطاسة، وطالبًا واحد شاي لتعمير الراس، والانخراط في الطش من جديد، وتسجيل الحساب في الكراس.. وقبل محله بأمتار يجلس الخال محسب، فاذا مررت به، لن تعرف كيف يكون الفكاك، وهو يحتفي بك قبل أن يسمعك، كأن لم يكن أمامه سواك! يظل يحكي عن جدتي وجدي، ويتنقل من الفرع الى الفروع، تسبقه الدموع، وكأنه سيلحق بمن رحلوا ومن سافروا الى محطة اللا رجوع! شيئا فشيئا.
ومع وفاة الجيل الأول من صانعي الطعمية، وناثري البهجة، ظهر جيل جديد، يضم المعلم سيد عبدالغني، بطيبته المتناهية، والمعلم حربي بمهارته الفائقة، وتجربته الناجحة في جدة، قبل أن تظهر أجيال جديدة.. المدهش في هؤلاء جميعًا، وفي أولادهم، قربهم الروحي والمكاني من بيوت الله، دعاة ومؤذنين، وعمال، ومعلمين، وكأنهم كانوا يصنعون عجينة «الخير والبركة» في كل اتجاه!
المثير في موضوع الطعمية، أن محطتي الأولى في مشواري الصحفي كانت في المبنى القديم لجريدة «الجمهورية»، حيث يتصدر محل «التابعي الدمياطي» أشهر محلات الطعمية في مصر في ذلك العصر المكان، والأكثر اثارة أن أمهر صانع لعجينة الطعمية في المحل ذاته «فتحي طايل» كان من قريتي.. من الرملة!
فلما دارت بنا الأيام والأعوام، أجدني أستقر الآن في جريدة «المدينة العريقة» حيث القرب من أشهر محلات الطعمية «نجف»! والواقع أن الفرق بين المحلين، هو أن الحالة الصحية والهضمية، في حالة «الجمهورية» كانت تسمح أحيانًا بالتهام 6 «صندويتشات» يوميًا على الأقل، فيما أكتفي باثنين كل ثلاثة أيام في حالة «المدينة».. وفي الحالتين فان الشعور المصاحب أثناء الشراء، واثناء الطعام، هو البهجة!
الآن، كلما مررت بسيارتي في ليل قريتي بشارع الطعمية، أتذكر روائح الزيت والبهار، وكيف عدونا وراء النهار، وكيف كان جمال الحوار، وكيف كان الدعاء الجميل، تارة بالنجاح وأخرى بالزواج، وثالثة بالعمر الطويل.. أقول.. لو عاد بي العمر، لقبلت كل الأيادي التي أطعمتنا صغارًا، وجعلت صباحنا جميلاً ومثيرًا.. أتذكر كيف كانت تطل من عيونهم فرحة ونشوة ورغبة جامحة في اطعام الطلاب الجياع، وكيف كانوا يدعون من قلوبهم ألا تنزوي أو تنمحي أحلامنا أو تضيع!
ولأنه بات من الصعب، قررت أن أعود للكتابة لهم ومن أجلهم.. وجدتني أستل قلمي، وأجهز ورقي، لأكتب عنهم فصلا مدهشًا في كتاب الأيام!
وهل كان الحصول عليها صعبًا لهذه الدرجة، أما لا!
وكنا مع نسمات الديمقراطية التي هبت على فترات متقطعة في عهد الرئيس السادات، نستمع للشيخ إمام وهو يردد مع الشاعر فؤاد نجم، ما قالاه في السجن بعد نكسة 1967 على سبيل الطمأنة والسخرية في آن واحد: «يا أهل مصر المحمية بالحرامية.. الفول كتير والطعمية والبر عمار.. والعيشة معدن وأهي ماشية وآخر أشيا.. مدام جنابو والحاشية بكروش وكتار» كما استوقفتنا كثيرًا تلك المداخلة أو المساجلة بين الشارع الذي يعاير الحارة، في قصيدة صلاح جاهين، قائلا: «إخييه! ريحتك طعمية، وفول وبصارة.. آييياه! كل بيوتك بغدادلى، مافيهاش تكييف.. وبيبانك نازلة لتحت، بدل ماهى طالعة لفوق، ولا حتى ليكى رصيف!
وستاتك بلدي، وليل ونهار ع العتبة، قاعدين كده جوق.. رجالتك نكتة وعجبة، ولا يعرفوا ذوق، وعيالك دول، نسانيس مقاصيف الرقبة! الحارة ردت رد... خلى الشارع ينسد»!!.
والحق أن شارع الطعمية الرئيسي في قريتي لم يعاير أي حارة، ولم يكن البيع والشراء فيه خاضعًا لحسابات الربح والخسارة! يطلع النهار، وقبل أن نتوجه لمدرسة علي الشيخ، وقبل موعد الطابور، ينطلق صوت «البابور»، ويصبح الشارع مضمخًا برائحة الطعمية والفول، والبهار.. نتقاطر على الشارع كالعصافير! تختلط رائحة الزيت، برائحة الكتب والكراسات! فاذا ما حال الزحام دون الحصول على «شقة وطعمية» انتظرنا لجرس الفسحة، فعدنا من جديد للشارع الجميل! في المحل الأول، يقف العم سعد، وبجواره زوجته الطيبة، يهشان في وجوه الزهور.. يدق قلبهما مع قطار الخامسة، فقد حان موعد القيام، للاتيان بكافة المكونات، من بقدونس ومن بصل ومن كرات.. تقف الزوجة شامخة وشاهقة، تنصح الكبار، وتضحك في وجوه الصغار، كأنهم عصافير، تود لو أطعمتهم كلهم، قبل انغلاق باب المدرسة، ويصبجون خلف السور! وفي المحل الثاني، يقف الوديع عبدالله، الذي لم ينهر يومًا فتى أو فتاة.. حيث الرضا أول ما يرى فوق الجباه، وحيث الدعاء بالنجاح أول ما يخرج من الشفاه! وفي المحل الثالث، يضبط العم زيدان ايقاع يومه على أصوات البوابير، فان تعطل أحدها في ثانية، بادر بتغيير «الطربوش» أو «الفونية»! وفي الجهة الثانية من القرية «الناحية دكهه» يقف الخال السيد عمر صانع البهجة، مزهوًا بما يخرج من الطاسة، وطالبًا واحد شاي لتعمير الراس، والانخراط في الطش من جديد، وتسجيل الحساب في الكراس.. وقبل محله بأمتار يجلس الخال محسب، فاذا مررت به، لن تعرف كيف يكون الفكاك، وهو يحتفي بك قبل أن يسمعك، كأن لم يكن أمامه سواك! يظل يحكي عن جدتي وجدي، ويتنقل من الفرع الى الفروع، تسبقه الدموع، وكأنه سيلحق بمن رحلوا ومن سافروا الى محطة اللا رجوع! شيئا فشيئا.
ومع وفاة الجيل الأول من صانعي الطعمية، وناثري البهجة، ظهر جيل جديد، يضم المعلم سيد عبدالغني، بطيبته المتناهية، والمعلم حربي بمهارته الفائقة، وتجربته الناجحة في جدة، قبل أن تظهر أجيال جديدة.. المدهش في هؤلاء جميعًا، وفي أولادهم، قربهم الروحي والمكاني من بيوت الله، دعاة ومؤذنين، وعمال، ومعلمين، وكأنهم كانوا يصنعون عجينة «الخير والبركة» في كل اتجاه!
المثير في موضوع الطعمية، أن محطتي الأولى في مشواري الصحفي كانت في المبنى القديم لجريدة «الجمهورية»، حيث يتصدر محل «التابعي الدمياطي» أشهر محلات الطعمية في مصر في ذلك العصر المكان، والأكثر اثارة أن أمهر صانع لعجينة الطعمية في المحل ذاته «فتحي طايل» كان من قريتي.. من الرملة!
فلما دارت بنا الأيام والأعوام، أجدني أستقر الآن في جريدة «المدينة العريقة» حيث القرب من أشهر محلات الطعمية «نجف»! والواقع أن الفرق بين المحلين، هو أن الحالة الصحية والهضمية، في حالة «الجمهورية» كانت تسمح أحيانًا بالتهام 6 «صندويتشات» يوميًا على الأقل، فيما أكتفي باثنين كل ثلاثة أيام في حالة «المدينة».. وفي الحالتين فان الشعور المصاحب أثناء الشراء، واثناء الطعام، هو البهجة!
الآن، كلما مررت بسيارتي في ليل قريتي بشارع الطعمية، أتذكر روائح الزيت والبهار، وكيف عدونا وراء النهار، وكيف كان جمال الحوار، وكيف كان الدعاء الجميل، تارة بالنجاح وأخرى بالزواج، وثالثة بالعمر الطويل.. أقول.. لو عاد بي العمر، لقبلت كل الأيادي التي أطعمتنا صغارًا، وجعلت صباحنا جميلاً ومثيرًا.. أتذكر كيف كانت تطل من عيونهم فرحة ونشوة ورغبة جامحة في اطعام الطلاب الجياع، وكيف كانوا يدعون من قلوبهم ألا تنزوي أو تنمحي أحلامنا أو تضيع!
ولأنه بات من الصعب، قررت أن أعود للكتابة لهم ومن أجلهم.. وجدتني أستل قلمي، وأجهز ورقي، لأكتب عنهم فصلا مدهشًا في كتاب الأيام!