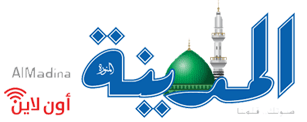الإسلام السياسي مصطلح حادث نسبيًّا، ظهر -ممارسةً- على السطح قبيل منتصف القرن الميلادي الماضي، حينما قامت بعض الجماعات بمحاولة الإمساك بزمام الأمور تحت شعارات تحكيم الإسلام وبسط نفوذه، مستخدمة العنفَ والتكفيرَ، ثم استقر -مُسمًّى- فيما بعد. هذه الشعارات تَبين للجميع في نهاية الأمر أنها ما كانت إلا جسرًا للوصول لغايات بعيدة تتمثل في الإمساك بزمام السُّلطة وتوظيفها لمطامعها، وما (طالبان، وإيران وأحزابها، والعدالة والتنمية، والإخوان) عنا ببعيد. ما تواطأ عليه المهتمون بأمر الإسلام السياسي هو أن هناك تيارات مضادة تقف موقف الاختلاف معه، كـ(الليبرالية والعلمانية..)، التي لها مساراتها وغاياتها المتباينة مع مساراته وغاياته. الأمر المفاجئ هو أن أحد هذه التيارات تشرِّع أدبياته للإسلام السياسي اقتسامَ السُّلطة مع الدولة، مما يسحب منها جزءًا من سُلطتها وسيادتها السياسية. هذا ما أكدته مجلة (الفكر المعاصر - الإصدار الثاني - أكتوبر ٢٠١٩م) التي تصدرها الهيئة المصرية للكتاب، وجاء ضمن دراسة الدكتور أشرف منصور أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية بعنوان (الدين وحقوق السيادة السياسية..). انطلق منصور من فرضية تقول «إن الخلاف الحالي حول الشرعية السياسية وحول العنف، مع كل المشكلات التي تثيرها ظاهرة الإسلام السياسي هو نتيجة لعدم القدرة على التمييز بين الديني والسياسي، وللخلط بين حقوق الدين وحقوق الدولة». وقد استعان في دراسته بالتراث الفكري الذي ينقد الخلط الحاصل بين الديني والسياسي، وركز على أعمال المفكر الألماني (كارل شميت ١٨٨٨-١٩٨٥). في البدء مهد منصور لدراسته برأي قديم لعلي عبدالرزاق -سبق به قيام جماعة الإخوان المسلمين- ونص على أن «الدين في ذاته، ومن جهة ارتكازه على البعد الروحي وتعبيره عن العلاقة بين الإنسان والله، لا يطمح لأن يكون مَصدرًا للسيادة السياسية»، وأوضح منصور أن (الحاكمية) لدى الإسلام السياسي «ما هي إلا مماثَلةٌ ونقلٌ لنمط السيادة السياسية إلى المجال الديني»، مؤكدًا على أن فكر الحاكمية مَنشَؤُه «فراغ سياسي كان يجب أن تملأه الدولة العربية لكنها لم تفعل». ينتقل منصور بعد هذا المهاد ليؤكد على أن مفهوم العلاقة بين الدولة والشعب يجب أن تكون مباشرة؛ حيث يمثل الشعب مصدر السلطات التي تتمثل في الدولة ومؤسساتها بوصفه مفهومًا حداثيًّا ديمقراطيًّا شعبيًّا، لكنه -وهنا الشاهد- يستدرك على (الليبرالية) أنها تسمح «بأن يكون للهويات الدينية والثقافية استقلال ذاتي وحق في تمثيل نفسها سياسيًّا». ويعيب على الليبرالية الجديدة أنها تنظر للدولة على أنها «شر لا بد منه، وأنها يجب أن تُقيَّد في سلطاتها وفي شرعيتها»، ويذهب إلى أن المدهش في الأمر «أن يكون هذا التصور الليبرالي للدولة وللمؤسسات المستقلة الوسيطة بين الدولة والشعب مناسبًا تمامًا لمشروع الإسلام السياسي»، مبينًا أن الدعوات الخبيثة لتطبيق نموذج الدولة الليبرالية التعددية المتطرفة هي التي تكمن وراء اهتمام الأكاديميات الغربية بالتنظير للإسلام السياسي، مستشهدًا بأبحاث معهد كارنيجي الأمريكي. النتائج المترتبة على اتخاذ الجماعات الدينية لنفسها وظائف سياسية يراها منصور تتمثل في «حروبٍ أهلية بين الطوائف الدينية وزوالٍ لسلطة الدولة» مستشهدًا بما وصفه هيجل وسبينوزا بـ»الانتقاص من سلطة الدولة والضعف العام في الكيان الاجتماعي كله»، ولا أظن ما حصل ويحصل في (أفغانستان واليمن والعراق ولبنان) إلا يصادق على هذا الوصف. أخيرًا يورد منصور رأي شميت في مسألة السماح بالتعددية الدينية وغيرها حيث يرى أن الفرد وقتها سيعيش في تعدد من الولاءات لجماعاتٍ دينية أو نوادٍ اجتماعية أو تجمعاتٍ ثقافية، لكنه لا يمانع من التعددية الداخلية -عكس الخارجية- المنضوية تحت سيادة الدولة والمعترفة بسلطة الدولة بوصفها كيانًا أعلى. الدراسة تستحق القراءة المتأنية، خصوصًا وقد أبانت خطر الأحزاب والجماعات -الإسلام السياسي مثالاً- وعرَّت الفكر الليبرالي الذي ظل منزهًا -عند أتباعه- ثم تبين لنا أن تصورَه -والإسلامَ السياسي- للدولة ينطلقان من منطلق واحد.